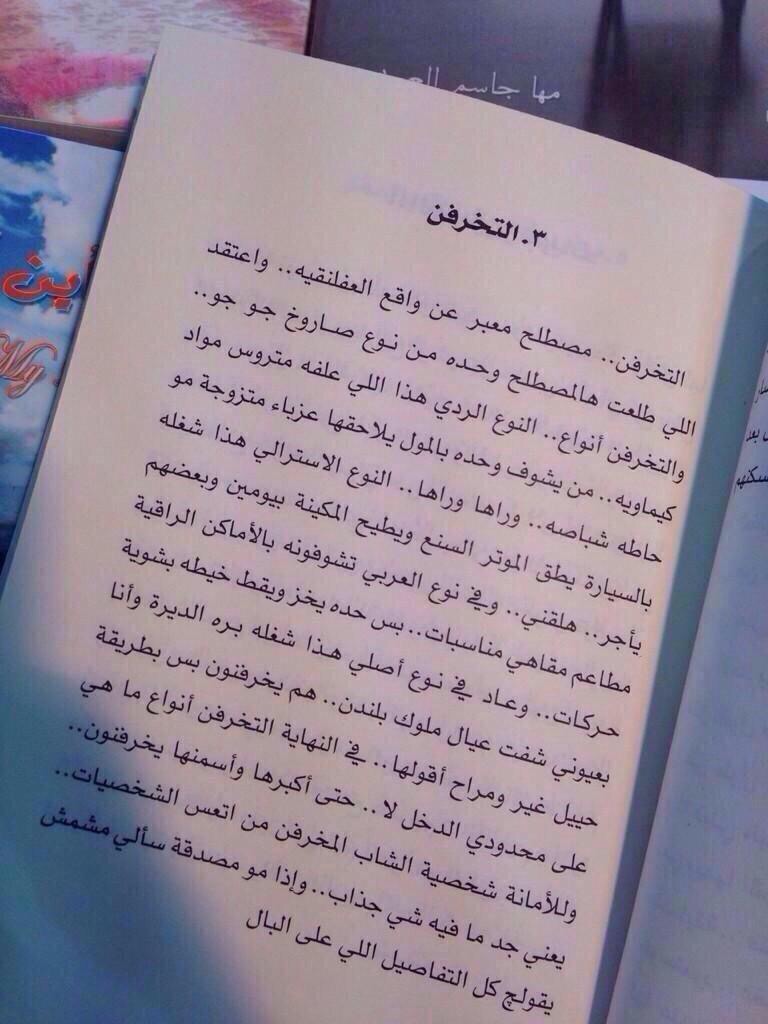إن كنت تبحث عن نقاش ديني ثيولوجي حول حكم العين والحسد وحقيقتها في ظل الكتاب والسنة والخلاف الديني/العلمي بالمسألة فاسمح لي أن أقول لك بأنك في المكان الخطأ! حديثي في موضوع الحسد والعين سيكون ثقافيا بحتا حول تأثير هوس الناس بهذا الموضوع على طريقة تفكيرهم وعلى تصرفاتهم وعلاقاتهم الاجتماعية وحتى توجهاتهم الاقتصادية، إن كنت ترى هذا الجانب «المحسوس» أكثر أهمية لديك من الجانب «الغيبي» فاستمر معي، مع تأكيدي لك بأنك ستقرأ جانبا من الموضوع ربما لم يخطر على بالك من قبل.
الفرق بين الحسد والعين
بالبداية يجب أذكر سبب اختياري لعنوان ثقافة الحسد والعين، مالفرق بين الحسد والعين؟ الحسد(Envy)يقصد به الإحساس بالنقص عند ملاحظة وجود شيء قّيم لدى الغير (مال، أولاد، مكانة اجتماعية… الخ)، فهو إذن شعور نفسي موجود لدى جميع البشر بدرجات متفاوتة، قد يصحب هذا الشعور نزعة حقد تتمنى زوال ذلك الخير من الآخرين، أثر الحسد النفسي والاجتماعي بكثير من الأحيان يكون سلبيا، في حالات معينة قد يكون الحسد إيجابيا إن أدى بالحاسد إلى أن «يشد حيله» ليحصل على خير مشابه للآخرين.
أما العين (Evil Eye) فهي الاعتقاد بقدرة الشخص على إلحاق الضرر بالآخرين عن بعد (عن طريق النظر كما هو شائع)، عادة ما ترتبط العين بالحسد، فالاعتقاد السائد هو أن الحاسد عندما يشاهد ما يشتهيه لدى الغير فإن بإمكانه أن يصيبه بالعين ويسبب له الضرر… بقصد أو دون قصد.
منشأ ثقافة الحسد والعين
من خلال عملية بحث بسيطة يتبين لنا أن مبدأي الحسد والعين موجودان في العديد من الثقافات والديانات والمعتقدات، بالنسبة للحسد فقد حذر منه القرآن كما دعت لاجتنابه الديانات اليهودية والمسيحية والهندوسية والبوذية بالإضافة لحديث الفلاسفة وعلماء النفس عنه، ذلك الاهتمام بأمر الحسد شيء طبيعي لأن أثره النفسي والاجتماعي واضح ومحسوس.
بالنسبة للعين فالأمر مختلف، العين ترتبط بالغالب بالجانب الثقافي من المجتمعات أكثر من الجانب الديني، وجدير بالذكر أن أهم الشعوب المتأثرة بالاعتقاد بالعين هي شعوب الشرق الأوسط ومنطقة حوض البحر المتوسط بالإضافة لبعض مناطق جنوب شرق آسيا وأمريكا الوسطى، قد تكون هناك شعوب أخرى لها اعتقادات مشابهة لم تطلها الدراسات ولكن الملاحظ بأن التركيز هنا على منطقة ما يطلق عليه اسم حضارات العالم القديم، هذا الأمر هام بالنسبة لنا لأنه من خلال دراستنا لتاريخ هذه المنطقة سنجد ارتباطا وثيقا بين تلك المناطق بسبب الاتصال الحضاري بينها مما أدى لتناقل التجارب الثقافية مثل الفنون والحرف والصناعات وحتى بعض مظاهر المعتقدات والأديان على مر القرون، لن أخوض بهذه المسألة أكثر حتى لا نخرج عن مسار حديثنا.
النظرية القائلة بقدرة العين على إصابة الآخرين بالضرر يرجع تاريخها إلى الإغريق (أو الفراعنة كما يذكر البعض) وتستند على فرضية أن أشعة الإبصار التي تخرج من العين قد يكون لديها قوة التأثير المادي بالمنظور، هذه النظرية بالطبع تعتمد على فكرة أن العين تبصر عن طريق الأشعة المنطلقة منها… لكن علماء مثل الحسن بن الهيثم أثبتوا خطأ هذه النظرية منذ قرون طويلة لأن العين لا تطلق أي أشعة بل تبصر عن طريق استقبال الأشعة المنعكسة عن الأجسام… لكن دعنا من الإثباتات العلمية حاليا، ما يهمنا هنا هو أن جزءا من الإرث الحضاري الثقافي القديم (بما فيه ما يتعلق بالعين) نشأ في اليونان أو انتقل منها إلى الحضارة الرومانية… ومنها إلى بقية أرجاء المنطقة، ذلك الإرث الثقافي نجد آثاره بالفن والعمارة واللغة والديانة، الثقافة بالطبع شيء مرن ومتغير ومرتبط بالقوة والسيطرة الحضارية، لذلك من الطبيعي أن تنتقل فكرة مثل فكرة العين إلى مختلف المناطق والحضارات التي وقعت تحت تأثير الحضارة الرومانية أو اتصلت بها ثقافيا، ومن هذه المناطق طبعا منطقتنا العربية، لا أدعي هنا بأن ذلك هو المصدر الوحيد لفكرة العين ولكني أحاول أن أقدم تحليلا تاريخيا منطقيا لذلك، ما يهمنا هو أن فكرة العين قديمة ومنتشرة في مناطق معينة من العالم وأن لها أصل ثقافي وتفسير شبه علمي تناقله البشر على مر القرون وأن مناطق أخرى قد لا تكون تأثرت بنفس الفكرة.
هل العين حقيقة؟
ذكرت بالبداية بأني لن أدخل بهذا النقاش وإن كان هنا هو المكان المنطقي له، لذلك سأترك لكم هذه المساحة الفارغة:
[ أدخل الجدال هنا ]
آثار الحسد الحقيقية
المقصود بالآثار الحقيقية هو الأثر النفسي والاجتماعي للحسد وليس الأثر الإشعاعي للعين، وهنا لا بأس من استذكار أن القرآن الكريم حذرنا من خطورة الحسد ودفعنا للاستعاذة من شره، كما أن الحسد يعتبر أحد الخطايا السبع المذكورة بالتوراة، وتحذر منه كذلك مختلف المعتقدات والفلسفات الإنسانية.
دون الإطالة بالطرح فقط نستذكر أن الشعور بالحسد تجاه الآخرين له ضرر على نفس الحسود، وذلك بالتالي قد ينعكس على تصرفاته التي قد تسبب الضرر للآخرين، فالحاسد تتكون لديه عقدة النقص عندما يقارن نفسه بالآخرين، وذلك قد يدفعه إما إلى الشعور بالإحباط والاكتئاب أو يدفعه إلى تعويض النقص الذي يشعر به بطريقة أو بأخرى، وتعويض النقص نجد آثاره الاجتماعية حولنا بكثرة خاصة في ظل المجتمع الاستهلاكي المعاصر، فيظهر على شكل تهافت على الماديات والكماليات أو على شكل تصنّع بالمظهر والتصرفات، في بعض الأحيان نجد الحسد الناجم عن مقارنة النفس بما يشاهَد بالإعلام من مظاهر الرفاهية المادية يدفع البعض إلى السعي وراء تحصيل المال بأسرع السبل وبأي طريقة ممكنة… بالاقتراض مثلا… أو حتى باللجوء للحصول عليه بالطرق غير القانونية، ومن ذلك تنشأ لدينا مشاكل اجتماعية جمة مثل الاتكالية على الغير وعدم الإنتاجية وحتى الفساد، ولا أزعم بأن الحسد لوحده هو المسبب لتلك المشاكل… بل هو واحد من العديد من العوامل التي يكمل بعضها البعض.
الحسد كذلك قد يصل ضرره المباشر إلى الغير، فالحاسد قد تكون لديه القدرة على إلحاق الضرر المادي على المحسود… حسيا وليس عن طريق الإشعاعات! فقد يلجأ الحاسد إلى تعطيل مصالح المحسود أو تخريبها أو تشويه صورة المحسود أو الحط من قيمة منجزاته أو السخرية منها، هذه العقلية التخريبية تولد لدى الحاسد شعورا بالتفوق والقوة، القضاء على منجزات الناجحين أو الساعين للنجاح أو تعطيلها أو السخرية منها أو الحط من قدرها (حتى ولو بحجة تطبيق اللوائح أو القوانين أو الروتين أو درء الفساد أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر… من وجهة نظر ما) يعطي الحاسد شعورا بالأهمية ويمثل له تعويضا لعقدة النقص التي يعاني منها. قد أكون تطرقت لأمر مشابه لذلك عندما تحدثت عن “التنمر” في مقال سابق.
علينا هنا أيضاً أن ننظر لموضوع الحاسد والمحسود من الزاوية المقابلة والتي لا تقل أهمية آثارها عن ما ذكرنا في القسم السابق، بعض الناس لديه شعور مبالغ فيه بأنه… محسود، وآثار ذلك كارثية كما سأفصل!
المنظول
كما أن البعض يبالغ في النظر إلى الآخرين على أن حظوظهم بالحياة أفضل منه نجد فئة أخرى من الناس ترى أنهم دائما معرضون للحسد (والعين) من قبل الآخرين! يمكن تقسيم سبب هذا الخوف من الحساد إلى سببين: فقد يكون ذلك أحد آثار الشخصية النرجسية أو المغرورة التي ترى نفسها بمكانة أعلى من الآخرين… وبالتالي ستكون معرضة أكثر من غيرها لحسد الحاسدين الذين لا يستطيعون الوصول لما وصلت إليه أو الحصول على ما حصلت عليه، والسبب الآخر هو مجرد الهوس بآثار العين الإشعاعية! أو قد يكون الخوف من الحساد يرجع لاجتماع السببين معا.
الفئة الأولى من الشخصيات المقيدة بفكرة أنها محسودة تميل حالتها إلى التأزم النفسي، لست بطبيب ولا عالم نفسي حتى أحلل الشخصية النرجسية وأسباب تكونها وطريقة علاجها، لذلك لن أتعرض لها بالتفصيل في هذا المقال.
أما الفئة الثانية وهي الشخصية المهووسة بأفكار العين والحسد فمشكلتها ثقافية أكثر منها نفسية، الشخصية النرجسية التي تظن بأن الجميع يحسدها ويحاربها ويحقد عليها موجودة في جميع المجتمعات حول العالم، لكن الثانية وجودها مرتبط بتأثرها بفكرة متداولة في المجتمع الذي تعيش فيه، والهوس بفكرة العين أو الحسد قد يكون له تأثير مقيد للفرد وللمجتمع ككل كما سأفصل تاليا.
قيد الحسد والعين
وجود قوة خارجية سلبية باستطاعتها التأثير على مجرى حياة الإنسان هي فكرة لها تأثير خطير على القرارات التي يتخذها وعلى تبريره لهذه القرارات… حتى لو كانت هذه القوة الخارجية وهمية أو مفتعلة، شعورنا بأن هناك من يراقبها وينتظر زلتنا ويريد الشر لنا يجعلنا نعيد التفكير مرارا قبل أن نقدم على أي خطوة بحياتنا، لا أتحدث هنا عن إعادة التفكير بالقرار بغرض التأني وتخطيط الخطوات فذلك أمر طبيعي لمواجهة عقبات الطريق المحتملة، لكن أتحدث هنا عن التردد خوفا من تأثير قوة خارقة غير متوقعة وغير منطقية يمكنها أن تغير مجرى القدر بأي لحظة دون أدنى سيطرة منا عليها!
كم من موهبة كتمت خوفا من الحسد؟ كم من قوة قمعت خوفا من العين؟ كم من جمال أخفي خوفا من أن «ينظل»؟! لا يمكن للمجتمع أن ينهض دون طموح ودون تنافس بالإنجازات، فإن كان هذا الطموح وهذا الإنجاز يوؤد بالمهد ولا ُيتحدث عنه بسبب الخشية من أن يتعرض صاحبه للعين أو للحسد فكيف السبيل؟
أوضح مثال على ما أقول هو تعاملنا مع الأطفال، أطفالنا رغم براءتهم وانطلاقهم الطبيعي في الحياة – حالهم حال الأطفال في كل مكان في الأرض – نجدهم يتعرضون لكبت وضغط اجتماعي خطير يقتل تلك البراءة ويكبل ذلك الانطلاق، لاحظ تصرفات الأطفال في المرة القادمة التي تدخل فيها مجمعا تجاريا أو حتى بتجمعكم العائلي الأسبوعي، شخصيا لا أرى أطفالا بقدر ما أرى بالغين بأجسام صغيرة، «لا تركض!».. «لا تغنين!».. «لا تلعب!».. «خليج يمي!».. «لا تضحكونه وايد!»… «لا تصورينه!»… «لا يكون تحط الصورة بالانستاجرام!».
مثال آخر على الضرر الاجتماعي لهوس الإصابة بالعين أو التعرض للحسد هو فكرة أن كل من ينتقد أو يتحدث عن شخص أو مؤسسة أو مشروع ناجح يعتبر حاسدا ويريد الشر! نعم ذكرت في فقرة سابقة بأن الحاسد قد يسعى للإضرار بالناجحين بالقول أو بالعمل، لكن الانتقادات هنا يختلف بعضها عن الآخر، الانتقادات الجارحة أو المضرة بالتأكيد يجب أن تكون مرفوضة لأنها قد تدخل في سياق التنمر، لكن النقد العلمي الهادف بقصد الدراسة أو التطوير أو الاستفادة من تجارب الغير هو أمر مختلف تماما. لا أود هنا التركيز على أصول النقد العلمي ولكني مضطر لتقديم أمثلة عن الفرق بينه وبين الانتقاد الشخصاني حتى يتبين لنا الفرق:
عندما أنتقد شكل ممثلة وطريقة كلامها أو لبسها لأن ذلك أمر “لا يعجبني” أو أراه “ينافي قيمي التي تربيت عليها” فنقدي هنا شخصاني ولا فائدة منه، لأن “ذوقي” و“قيمي” الشخصية التي تربيت عليها وآمنت بها ليست مقياسا يعمم على كافة البشر، فالذوق والقيم تعتبر رموزا متغيرة المعنى والدلالة حسب السياق الثقافي كما أوردت في مقالات سابقة. ونعم، قد يكون انتقادي لهذه الفنانة أو تلك الشخصية المعروفة ناتج عن “حسد” مني لمكانتهم! لأن تلك الشخصيات المنتـَقدة لو كانت شخصيات عادية أو مغمورة أو فاشلة لما اثارت اهتمامي ولما أتعبت نفسي في انتقادها، أركز على كلمة “قد” يكون حسدا… لأنه قد يكون راجعا لأي عقدة نفسية أخرى، وحديثي هنا هو لتقديم مثال على النقد الشخصاني غير العلمي على كل حال.
من ناحية أخرى، عندما أنتقد شخصية رجل أعمال ناجح مثلا متحدثا عن ضرر حقيقي (اجتماعي أو اقتصادي) تتسبب به هذه الشخصية مبديا أسبابا مادية يمكن قياسها دعتني للتصريح عن انتقادي هذا فالأمر مختلف، عندما أتحدث عن البيئة الاجتماعية والثقافية التي أنتجت هذا الشخص وعاونته على أن يفلت من قبضة الرقابة المالية (مثلا) فإني بعيد كل البعد عن الحسد «الشخصاني» لهذه الشخصية… أو تلك المؤسسة أو ذلك المشروع. كذلك الأمر بالنسبة للممثلة المشهورة، لو انتقدت تصرفات مضرة ضررا ماديا حقيقيا أو غير قانونية تقوم بها، أو انتقدت فكرة تقوم بترويجها، أو حتى انتقدت أسلوبها في التمثيل أو الغناء لعدم مطابقته للأصول الفنية أو الأكاديمية (وليس ذوقي الشخصي)، فإني هنا لا أحسدها… ولكني أنقدها نقدا علميا غير شخصاني.
نرجع لمسألة قيد الحسد والعين ونذّكر بأن الحديث هنا ليس على مستوى ا لأفراد وحسب، بل تقع المجتمعات كاملة أحيانا فريسة للرهبة من الحسد، فنجدها تبني أسوارا حولها تنظر لكل ما هو داخلها على أنه جميل وكامل وأن كل ما يأتيها من خارج هذه الأسوار يجب التعامل معه بحذر لأن “الآخرين” يحسدوننا على كمالنا ورزانتنا وحسننا وجمالنا واستقامتنا، ارجع لمقال ثقافة السور للمزيد عن هذا الأمر. وهكذا فإن أي مجتمع ينظر لكل نقد يقدم له على أنه ناجم عن حسد وحقد ويرفض تقبل كلام الآخرين نتيجة تكبر ونرجسية أو إعلاء لشأن «المقدسات» التي يتمتع بظلها ولا يقبل المس بها سيكون مجتمعا جامدا يرفض التقدم والتجديد، فكيف يسعى للتقدم وللتجديد من يظن بأنه كامل أو يظن بأن هذه المؤسسة مقدسة وأرقى من أن تمس؟
خطوط الدفاع
ونأتي هنا لخطوط الدفاع الموجهة ضد الحسد والعين، فبعد العمليات الوقائية المتمثلة في إخفاء وتمويه وكبت المرشح للعين وتسويره بالأسوار الثقافية نأتي للمرحلة الثانية وهي تسويره بمضادات العين، ومضادات العين تأتي بعدة أشكال وأنواع حسب المعتقدات السائدة لدى المجتمع.
هناك فئات من المجتمعات تؤمن بقدرة بعض المواد أو الأشكال أو الألوان على امتصاص أشعة العين الحاسدة، فيقومون برسمها أو تعليقها بالقرب من ما يخشى أن يحسد، أشهر هذه المواد هي الشذر بلونه الأزرق الشذري، والبخور أحيانا يستخدم لطرد العين، وكذلك اللعاب… عن طريق النفخ أو «التفل»!
كذلك من الأشكال المعروفة والشائعة هي ما يعرف بـ “كف فاطمة” لدى بعض المسلمين (أو الـ “خمسة” في بعض الأحيان)، وهي كذلك معروفة لدى المسيحيين باسم “كف ماري” نسبة لمريم العذراء، ولدى اليهود أيضا باسم “كف مريم” نسبة لمريم أخت موسى وهارون، ولا غرابة هنا في تشابه هذه الكفوف وأثرها نتيجة للتقارب والتبادل الثقافي الذي تحدثت عنه أعلاه، ونعم، هناك آثار لهذه الرموز ترجع لأيام حضارة بلاد الرافدين والحضارة الإغريقية وغيرها من حضارت المنطقة.
بعض المسلمين يرفضون الإيمان بقدرة تلك المواد أو الأوان أو الأشكال أو الرموز على إبعاد العين والحسد وضررهما، لكنهم قد يؤمنون بقدرة بعض الآيات أو السور القرآنية أو الأحاديث أو الأدعية على إبعاد تلك الشرور، ومرة أخرى نجدهم يتجنبون استخدام الرموز الكلاسيكية ويستبدلونها بتلك الرموز اللغوية البديلة على شكل كتابات أو لافتات أو منحوتات أو حروز (جيوب تخبأ الكتابات بداخلها) توضع حول المرشح للإصابة بالعين.
في بعض الأحيان يكون الإيمان ليس بقدرة تلك الكتابات بحد ذاتها على الحماية من الحسد والعين، ولكن الإيمان يكون بأن “التلفظ” بتلك الكلمات هو ما يوفر الحماية، بالتالي تعلق أو تكتب في مكان استراتيجي حتى يضطر كل “راء” على قراءتها والتلفظ بها وبالتالي يتم لها أن توفر منظومة حماية آلية من أي نظرة قد تخفي شيئا من الشر.
هناك أساليب أخرى لا تتضمن استخدام كتابات أو رموز مرئية، من هذه الأساليب هي ذبح الذبائح أو إقامة الموائد أو توزيع الصدقات أو الهبات للآخرين، فمن المتعارف عليه لدى بعض المجتمعات بأنه إن قام شخص بشراء بيت جديد أو سيارة جديدة فإنه يتعين عليه أن يذبح ذبيحة بهذه المناسبة درءا للعين، أو أن يقيم مأدبة عشاء إن حصل على وظيفة أو تزوج أو تخرج أحد أبناءه لنفس الغرض، وأحيانا يُـلحق بهذ الغرض أغراض أخرى كإظهار الفرح أو حمد الإله وشكره على النعمة… يعني ليس فقط لأجل الحسد والعين. وبصراحة فإن قدراتي البحثية عجزت عن إيجاد تاريخ هذا التقليد أو أصله الثقافي أو جذوره الثيولوجية أو الأنثروبولوجية.
وهناك أيضا خط حماية ثالث يتعلق بطرق وأساليب إزالة وعلاج العين، لا أود التطرق لذلك لكي لا أدخل بالدين (إحلف!) لأني أود الاكتفاء بالحديث الثقافي.
والله يكافينا وياكم شر الحسد والعين… قولوا آمين 🙂