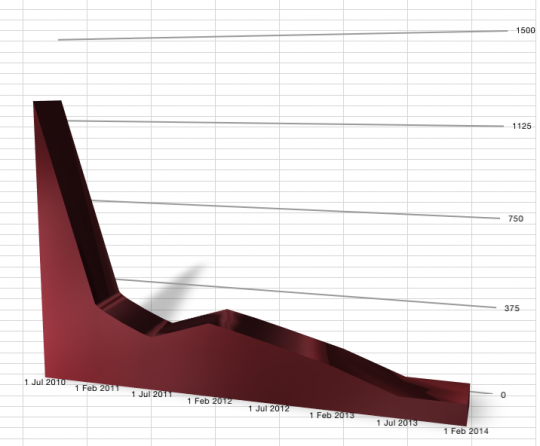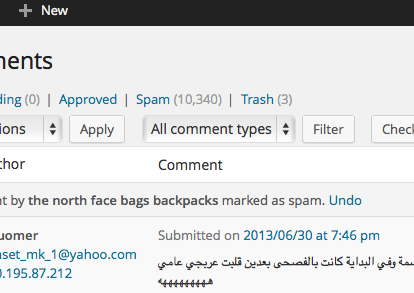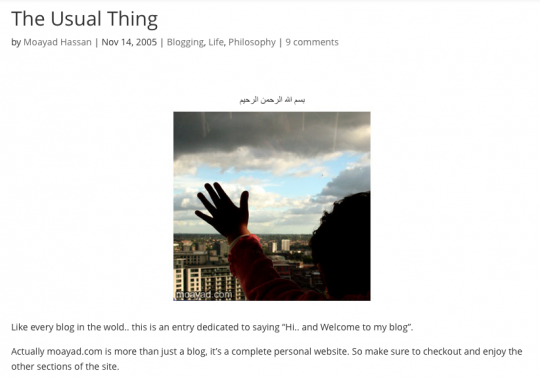واقعيا… نحن ما زلنا نروج للعنف على أنه “حق مشروع” ولا ضير منه! مع أنه لو تبصرنا بهذه الجملة لاستوجب علينا أن نخجل من أنفسنا صراحة! بالطبع للهروب من قباحة كلمة “العنف” فإننا نجمّلها ونستبدلها باسم “المقاومة” حينا وباسم “إعلاء الحق” حينا آخر… وإلى آخره من الكلمات الداعية إلى إقصاء “الآخر” الذي لا يعجبنا لأي سبب كان، أي كأنك تقول بأنه من حقك أن تقتل وتدمر وتشعل الفتن وتثير المشاكل فقط لشعورك بأنك “مظلوم” مثلا أو تجابه الشر أو حتى تحاول إثبات موقف، بل ومن حقك مقاتلة كل من ينكر عليك “حقك” هذا!

قبل أن أبدأ بإيضاح وجهة نظري – التي قد لاتعجب الكثير من القراء – بهذه المسألة علي أولا أن أعرف المقصود بكلمة “العنف”، يعرف العنف بأنه: “سلوك يتضمن استخدام القوة المحسوسة بغرض إلحاق الأذى أو الإضرار أو قتل شخص أو شيء ما”، ويطلق العنف كذلك على القوة العاطفية أو القوة الطبيعية المدمرة (التعريفات من قاموس أوكسفورد)، من ذلك نستنتج بأن المقصود بالعنف هو فعل التدمير بحد ذاته بغض النظر عن أهدافه إن كانت شريرة أو “سامية”.
فهل نحن كأمة عربية نهتم بهذا المعنى للعنف؟ يكفي القول بأن صفحة تعريف “العنف” بالويكيبيديا العربية وقت كتابة هذا المقال هي فقرة واحدة (٤-٥ أسطر)، بينما الصفحة الإنجليزية مجرد المرور السريع عليها يصيبك بالملل لطولها! الصفحة الإنجليزية تحتوي على ١٣٢ مصدرا، بينما العربية تحوي ٤ مصادر… مكتوبة باللغة الإنجليزية!! وهذا دليل مادي بسيط على مدى اهتمام ثقافتنا العربية بمفهوم العنف.
لكي تصل فكرة العنف لمستوى القبول كما هو موجود في ثقافتنا فإنه لا بد من أنه قد تمت عملية تأسيس ثقافي متين لها، فهي فكرة ليست هينة إطلاقا، التأسيس الثقافي لديه الإمكانية بأن يربط أي معنى بأي رمز إن مورس بشكل مركز ومخطط له، حتى لو كان ذلك المعنى غير منطقي، مثال على التأسيس الثقافي – كما أقوم بشرحه لطلابي – هو معنى الألوان، الألوان بشكل عام عبارة عن رموز، حالها حال الأشكال والكلمات والمفاهيم، والرموز يمكن أن تحمل عدة معان حسب المؤثرات الثقافية (مثل اللغة، التربية، التعليم، الديانه، الظروف الاجتماعية والاقتصادية… الخ)، فلو تم تدريسك وتأكيد فكرة أن اللون الأبيض مثلا هو لون حزين منذ طفولتك فستكبر وأنت مؤمن بهذا الأمر، فإن كبرت وشاهدت عروسا ترتدي فستانا أبيض بيوم زفافها ستستغرب وتستنكر الأمر!
قس الكلام المذكور أعلاه على مفهوم العنف وربطه بالشجاعة والكرامة والنخوة ودفع الظلم كما تم تعليمنا، إن كنت مؤمنا بهذا الإرتباط فإنك لا تلام بصراحة! نحن أمة نشأنا على تلك الأفكار العنيفة وتم تأسيسنا عليها ثقافيا عن طريق التربية الأسرية والمناهج الدراسية والسرد التاريخي والإعلام وحتى الدين، شاهد معي هذا المثال الصارخ حول الكيفية التي تتم بها زراعة العنف والكراهية بنفوس أطفالنا والذي أسردت لها مقالا كاملا يحمل عنوان زراعة الكراهية كنت قد كتبته عام ٢٠٠٨:
تحدثت في المقال عن امتعاضي من الإصرار على إذاعة هذه الأغنية الكارثية تربويا على إحدى قنوات الأطفال المشهورة (قناة سبيس تونز)، وكيف أن الخطورة ليست فقط في محتواها العنيف والإقصائي… بل بمحاولة بث هذه الأفكار وتعميمها على عقول كافة المشاهدين من الأطفال، يعني كل أب أو حتى مؤسسة تربوية قد يكون لهم الحق في تنشئة أبنائهم بأي فكر يريدون مهما كان غير مقبول بالنسبة لنا، لكن المصيبة هنا هي محاولة فرض هذه التنشئة على عامة أطفال الأمة، وقد يكون ما نشاهده ونقرأه اليوم من أفكار عنيفة يطرحها شباب التويتر هي – جزئيا – ناتج لما شاهدوه وسمعوه على سبيس تونز قبل ٦ سنوات، طبعا أنا هنا لا ألوم هذه الأغنية أو هذه القناة لوحدها كسبب لفكر العنف الموجود لدينا… فتلك سذاجة! ولكن كما بينت أعلاه فإنها منظومة ثقافية متأصلة ومتجذرة لدينا تبث هذه الأفكار والمفاهيم وتجعلها جزءا منسوجا ضمن خيوط نسيجنا الثقافي.
هل معنى ذلك أننا أمة كتب عليها أن تعيش العنف والكراهية ولا أمل لها بالتغير؟
طبعا لا!
الثقافة عملية مستمرة، تغييرها يحتاج لإيمان بأهمية التغيير وإصرار على المبدأ ومجابهة شجاعة للأفكار السائدة، وحديثي في هذا المقال ليس موجها لدعاة العنف بل هو لرافضيه، أدعوهم ليرتفع صوتهم وينجلي خوفهم من الأصوات العالية المحيطة بهم… وهي أصوات مرعبة بالفعل! دعاة العنف في مجتمعاتنا لا يستسهلون ممارسة ذلك العنف على مخالفيهم وحسب… بل يستسهلونه حتى ضد مع يطرح أفكارا نابذة للعنف الذي يدعون إليه حتى لو كانوا من أبناء جلدتهم، فالداعي للسلم ولنبذ العنف بالنسبة لهم تطلق عليه صفة الذلة والخنوع والاستسلام حينا والخيانة والعمالة حينا آخر، من الأمور التي طالما أصابتني بالحيرة هي أننا كلما اشتعلت أزمة من حولنا نسعد عندما نشاهد أو نسمع أحدا من “الطرف الآخر” يعارض العنف، لكن عندما تكون المعارضة من طرفنا فتصبح محرمة! تجدنا نسارع للمشاركة بنشر صورة للمظاهرات الداعية لوقف العنف ضدنا، لكن عندما نسمع رأيا يطالب بوقف العنف من قبلنا فإننا أوتوماتيكيا نسميه صوتا انبطاحيا صهيونيا… فيالها من موازين مختلة لدينا!
من خلال ملاحظاتي على تويتر مثلا وجدت أن من يشاركونني رأيي الداعي للسلم كثر… لكنهم صامتون! على عكس الرأي السائد الآخر، أنا نفسي كنت أؤثر الصمت كلما اشتعلت الأزمات وعصفت بالأمة من حولي، فبالصمت السلامة، لكني وصلت لمرحلة لم أستطع معها الاستمرار بذات الصمت! وأنا اليوم أدعوا المسالمين الصامتين أمثالي أن يكفوا عن ذلك…
قولوا لا للعنف! لا لزراعة الكراهية!
نعم للسلام… نعم لزراعة الحُب!
قولوا نعم للعلم، للفن، للأدب، للثقافة، للتنمية، للبناء، للعلاقات الطيبة، للمعيشة الرغدة، للإنسان وحياته وحقوقه البشرية!
اقرأوا التاريخ ثانية ليس بغرض المتعة أو التغني بالأمجاد أو التحسر على الماضي، بل اقرؤوه قراءة نقدية محايدة غير متأثرة بأكاسيد الأفكار السائدة المترسبة في عقولكم، ليس كل سائد صحيح، وليس هناك معنى عالميا لكل رمز، إن أدركنا هذه الحقيقة فسنكون قد خطونا الخطوة الأولى في طريق إصلاح المفاهيم، فإن فعلنا ذلك سنجد بأن ما من أمة حققت مجدا بعنف، لم يحدث نماء وسعادة لأي شعب أثناء حرب، بجميع حروب العالم… الفائز والخاسر فيها لم يتقدم ويتحضر ويقوى ويحقق الرخاء والسعادة إلا بعد أن يتم السلام والاستقرار.
الأمر بغاية البساطة ولا يحتاج لشهادة في الفيزياء أو الفلسفة حتى ندرك بأنه إن كان معي ألف دولار فيمكنني أن أشتري بها صاروخ غراد… أو أوفر بها علاجا أو وجبات طعام أو خياما تكفي لمساعدة ألف شخص، الخيار الأول خيار العنف والثاني خيار السلام، فماذا سنختار؟
——————
شارك برأيك على تويتر من خلال الهاشتاغ: